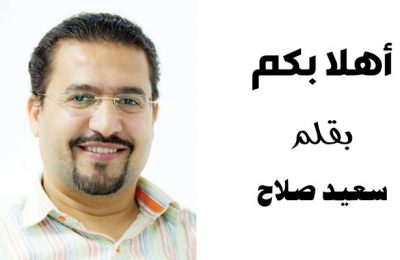الرئيسية متابعات موسوعة أحمد أمين..تاريخ الحياة الفكرية للمسلمين في خمسة قرون
متابعاتهام
موسوعة أحمد أمين..تاريخ الحياة الفكرية للمسلمين في خمسة قرون
 By amrأبريل 13, 2020, 16:38 م
By amrأبريل 13, 2020, 16:38 م
5373
في العام الأول لنا في الجامعة؛ كان العالم الجليل الدكتور محمود فهمي حجازي يدرس لنا مادة (المدخل إلى علم اللغة)؛ وكانت من أمتع المحاضرات وأغناها علما وفكرا وإثارة للأذهان وإنارة للعقول.. يخوض بنا غمار التراث القديم والدراسات المعاصرة بسلاسة ويسر وبراعة.
أذكر أنه في واحدة من هذه المحاضرات الرائعة؛ سأله واحد منا عما يمكن أن يبدأ به تعرفه على التراث الإسلامي في جانبه العقلي والفكري؛ لكن بصورة كلية وشاملة، وتغطي مساحة زمنية كبيرة…
جاءت إجابة الدكتور حجازي سريعة ومباشرة وموجزة “اقرأوا كتب المرحوم أحمد أمين كلها لا تنقصوا منها شيئا”. فلما استزاده الطلبة لبيان ما يقصد وسببه؛ أجاب أن السلسلة التي عكف على إخراجها المرحوم أحمد أمين، واستهلها بكتابه الأشهر «فجر الإسلام»؛ مما لا غنى عنه لأي طالب أو دارس أو باحث أو قارئ عام في تاريخ حضارة الإسلام، والثقافة الإسلامية، والفكر الإسلامي.
كتب : إيهاب الملاح
1
كان حديث الدكتور حجازي ملهما لنا جميعًا، وإن كنت على المستوى الشخصي قد قرأت لأحمد أمين كتبًا أخرى (منها سيرته الذاتية البديعة «حياتي» التي لم تنل ما تستحقه أبدًا من قيمة وتقدير وشهرة.. لكن هذا حديث آخر) وكنت قرأت شيئا بسيطا عن موسوعته تلك لكن بغير توسع ولا تفصيل (مقال مهم كتبه المرحوم الدكتور شوقي ضيف عن «ضحى الإسلام»). وجاءت إشارة الدكتور حجازي، عليه رحمة الله، كي تحسم بداخلي قرار البحث عن هذه الأعمال والبدء في مطالعتها.
2
لحسن حظي، وحظ جيلي كله في هذه السنوات البعيدة من تسعينيات القرن الماضي أننا شهدنا ميلاد مشروع (مكتبة الأسرة) الذي ندين له بالفضل الكبير في تيسير الحصول على روائع الأعمال الأدبية والفكرية بأسعار زهيدة ومناسبة.
وكان كتاب «فجر الإسلام»؛ وهو أولى حلقات بحث أحمد أمين حول تاريخ الحياة العقلية والفكرية للمسلمين، في طليعة الكتب التي ظهرت في المشروع عام 1994، ثم ظهرت بقية الأجزاء تباعًا فصدر «ضحى الإسلام»؛ في ثلاثة أجزاء على مدار ثلاثة أعوام (1997، 1998، 1999).. ولحسن الحظ أيضًا، فإنها جاءت مصورة عن الطبعة الأولى التي صدرت عن (لجنة التأليف والترجمة والنشر) التي كان يرأسها ويشرف عليها أحمد أمين نفسه.
وهكذا أتيح لي ولأبناء جيلي كله أن يقرأ هذا الأثر العظيم، وأن نعيد التذكير به الآن ونعرف به لأجيال جديدة بمناسبة صدور طبعة جديدة منه ضمن سلسلة (كلاسيكيات) التي تصدر عن الدار المصرية اللبنانية؛ وفيها تظهر هذه السلسلة مكتملةً للمرة الأولى بكامل حلقاتها وأجزائها التي تقترب من العشرة… طبعة جديدة، حققها وعلق عليها محمد فتحي أبو بكر، وقدم لها الأكاديمي والناقد المعروف د.صلاح فضل.
3
لكن وقبل الشروع في الحديث عن «فجر الإسلام، وضحاه، وظهره، ويومه» لا بد من إشارة إلى سيرة أحمد أمين (1886-1954) والتعريف به لمن لا يعرفه من الأجيال الجديدة، هذا الرائد النهضوي الكبير الذي كان أحد أضلاع المربع الذهبي في حياتنا الفكرية والثقافية المعاصرة «مع طه حسين، والعقاد، ومحمد حسين هيكل»، في النصف الأول من القرن العشرين.
المرحوم أحمد أمين (1886-1954م)؛ أحد أكبر العقول العربية في العصر الحديث، ورائد بارز من رواد نهضتنا الأدبية والثقافية في النصف الأول من القرن العشرين. إنه مؤرخ الحياة العقلية والفكرية للثقافة الإسلامية منذ ظهورها، ومؤسس العديد من الأنشطة والمعارف الثقافية والمؤسسات التي نمت وازدهرت وتطورت فيما بعد على يد تلاميذه وطلابه، وإذا ذكر اسمه ذُكرت على الفور موسوعته الرائعة (فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، يوم الإسلام) التي أرّخ فيها لجوانب الحياة العقلية والفكرية والاجتماعية للحضارة الإسلامية، منذ ظهور الإسلام حتى القرن الخامس الهجري.
ويقرن اسم أحمد أمين بأسماء عظماء جيله -طه حسين، محمد حسين هيكل، عباس محمود العقاد، أحمد حسن الزيات، مصطفى صادق الرافعي، توفيق الحكيم وغيرهم- ممن حملوا على أكتافهم مهمة النهوض بثقافة وفكر هذه الأمة خلال الفترة الزمنية التي عاشوها وأسهموا فيها إسهامات رائعة، متعددة ومتنوعة تنوع المجالات المختلفة التي رادوا فيها الطريق لغيرهم، ممهدين السبيل لمن أتى بعدهم في أن يكملوا ما بدأوه (أو هذا ما نقنع أنفسنا به الآن!).
ولد أحمد أمين في القاهرة في الأول من أكتوبر عام 1886، في أسرة محافظة تتمتع بقدر كبير من العلم والمعرفة، التحق بالمرحلة الابتدائية، ثم درس في الأزهر الشريف، ثم انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي التي تخرج فيها عام 1907، وعين عقب تخرجه قاضيا شرعيا، ثم مدرسا بمدرسة القضاء، ثم قاضيا في الواحات الخارجة سنة 1913، ثم مدرسا بكلية الآداب بالجامعة المصرية عام 1926، وظل مدرسا بها، فأستاذا حتى تولى عمادتها، كما عين في عام 1946 مديرا للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية، وكان أحمد أمين عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، والمجمع العلمي العربي بدمشق، والمجمع العلمي العراقي.
تنوع إنتاجه المعرفي تنوعا كبيرا، حيث زاوج في تكوينه الفكري وتأسيسه الثقافي بين ثنائيات عديدة كان لها مردودها البارز على تكوينه وثقافته.. فقد جمع بين ثقافة أزهرية عميقة وخالصة، وثقافة أوروبية حديثة حصلها بكده واجتهاده عن طريق تعلمه اللغة الإنجليزية، وكان قد جاوز الثلاثين حين بدأ في تعلمها.
واطلع إطلاعاً واسعاً مستوعباً على التراث العربي الإسلامي (وإسلامي هنا تشير إلى ما أنتجه المسلمون من فكر وحضارة وثقافة سواء كانوا عرباً أم غير عرب من الأجناس والأمم التي دخلت في الإسلام وأسهمت في عطائه الحضاري، مثل الفرس، والترك، والروم، والهنود، والبربر،…إلخ). كما اطلع على التراث الإنساني العالمي ممثلاً في روائع الفكر والأدب والفلسفة، تلك الروائع التي أبدعها عمالقة الفكر والإبداع على مر العصور..
كما تلاقت فيه إشكالية (التراث/ المعاصرة) بكل تجلياتها وأشكالها، وعلى كل المستويات بدءًا من زيه الأزهري التقليدي الخالص في بداية حياته والذي غيّره إلى الزي الأوروبي الحديث، مرورًا بتعليمه الذي جمع بين أطراف ثلاثة مثَّل كل طرف منها رافدًا مهما من روافد ثقافته وتكوينه.. فجمع بين التعليم الأزهري، والدراسة في مدرسة القضاء الشرعي -التي كانت تعد بمثابة نقطة التقاء بين التعليم الديني ممثلا في الأزهر وبين التعليم المدني الحديث ممثلا في الجامعة الحديثة- والتدريس بالجامعة المصرية الحديثة بكلية الآداب… وانتهاء بجمعه بين منهجين في الدرس والتحصيل والإبداع، أحدهما يمتد بجذوره إلى الثقافة العربية الإسلامية القديمة والآخر يتصل اتصالًا وثيقًا بالثقافة الغربية الحديثة بكل تجلياتها…
وقد كان لكل هذه العوامل -السابق ذكرها- أكبر الأثر في إمداده بالقدرة التحليلية النقدية الفائقة التي تميز بها، والرؤية العقلانية المستنيرة المتوازنة التي جعلته علمًا عليها ودليلًا ومرشدًا. وقد برزت هاتان السمتان في كل أعماله ومؤلفاتـــه، وبالأخص فــي عمله الموسوعي الضخم الذي نتناول تفصيلا في الفقرات التالية..
4
ولهذا المشروع العلمي الثقافي الجبار قصة لها مغزى تستحق أن تروى، رواها تفصيلا الدكتور طه حسين في تقديمه للجزء الأول «فجر الإسلام». لم يكن أحمد أمين مدرسا بالجامعة المصرية بل كان قاضيا شرعيا، ودعاه طه حسين بعد أن أدرك مواهبه وواسع ثقافته وعلمه كي يدرِّس بالجامعة المصرية (التي كانت أهلية، ثم صارت حكومية فيما بعد) عام 1926م.
وفي الجامعة، اتفق أحمد أمين، والدكتور طه حسين، وصديقهما المشترك المؤرخ عبد الحميد العبادي، على وضع وتنفيذ مشروع علمي ومعرفي طموح يسعى إلى دراسة الحياة الإسلامية من نواحٍ ثلاث: الناحية العقلية، والناحية الأدبية، والناحية التاريخيـــة فـي عصور الإسلام المتعاقبة منذ ظهـــوره؛ وحتى زمنهـــم المعاصـر، يختص د.طه حسين بالحياة الأدبية، وأحمد أمين بالحياة العقلية والفكرية، وعبد الحميد العبادي بالحياة التاريخية..
ولكن تشاء الأقدار أن ينجز أحمد أمين -وحده- مشروعه كاملاً دون زميليه اللذين حالت الظروف الخاصة بهما دون الوفاء بما وعدا به (وإن كانا قد قدّما جزءًا مما وعدا به فأخرج طه حسين مثلًا سلسلة كتبه المشهورة في تاريخ الأدب العربي؛ التي استهلها بكتابه المدوي «في الشعر الجاهلي»، ثم في «حديث الأربعاء» (ثلاثة أجزاء)، و«من حديث الشعر والنثر»… إلخ)
وخلال عشرين سنة تقريبًا أو يزيد، صدرت السلسلة المعروفة، المكونة من تسعة أجزاء؛ هي: «فجر الإسلام» (جزء واحد)، «ضحى الإسلام» (ثلاثة أجزاء)، «ظهر الإسلام» (أربعة أجزاء)، وأخيرا «يوم الإسلام» (جزء واحد).. وتناول فيها على الترتيب، بصبر وأناة ودأب منقطع النظير، الحياة الفكرية والدينية والثقافية والعلمية والاجتماعية للمسلمين خلال القرون الخمسة الأولى من الهجرة..
وتجدر الإشارة إلى أن أحمد أمين كان ينوي أن يصل بالسلسلة إلى العصر الحديث، بإصدار (عصر الإسلام)، ثم (الإسلام في عصر النهضة الحديثة).. لكن الأجل لم يمهله لكي يتم ما كان ينويه..
5
لماذا حازت هذه السلسلة من الكتب/ العلامات في الثقافة العربية الشهرة الطاغية التي نالتها؟ ولماذا تحتفظ بقيمتها حتى الآن؟ وكيف أتم أحمد أمين إنجازها؟
مثلما كانت كتب طه حسين في تاريخ الأدب العربي أول كتابة معاصرة تعتمد المنهج العلمي والتاريخي في درس ظواهر الأدب العربي؛ وكانت كتابات هيكل في الإسلاميات أول محاولة تاريخية منهجية في الثقافة العربية لكتابة سيرة الأماكن المقدسة، والشخصيات التاريخية البارزة، والشخصيــات الدينية المقدسة، كانت جهود أحمد أمين أسبق منهما في التأسيس لأول تناول علمي وتاريخي «وصفي» لما يمكن أن نطلق عليه «مسيرة العقل المسلم منذ ظهوره».
وأتصور أن طبيعة المرحوم أحمد أمين الهادئة المثابرة هي التي أتاحت له من الصبر ما أكمل به ما بدأه مع صديقيه؛ طه حسين وعبد الحميد العبادي من مشروع التأريخ للحضارة العربية في جوانبها المختلفة، السياسية، والفكرية، والإبداعية.
لم يكن هناك أعمال سابقه في موضوعه باللغة العربية، وكانت كل الكتابات المهمة والمرجعية لمستشرقين أجانب وبلغات أخرى غير العربية، ولم تكن كل ذخائر التراث العربي المهمة قد ظهرت في صورتها المحققة، كان معظمها مخطوطًا، وبالتالي فقد كان على أحمد أمين أن يتجاوز كل هذه الصعوبات والتحديات، وينجز هدفه الضخم عبر عمل دؤوب ومتواصل وبإرادة لا تلين؛ فيستعيض عن النقص الفادح في ذلك بنفسه؛ أولا بإجادته للإنجليزية، ومطالعة أهم المراجع التي كتبت في موضوعه بها، وينقل عنها فيما يكمل بحثه ويغنيه، وثانيا بأن يقوم بعملية مسح واستقصاء واسعة لنصوص التراث العربي والإسلامي (مخطوطا وهو الأكثر ومطبوعا وهو الأقل) يجمع منها مادته فيما يمكن أن يشكل معالم البحث في هذه الأرض البكر..
وفي رأيي، فقد كانت هذه العملية هي الأصعب لأنه كان لزاما عليه أن يقرأ كل كتب الأدب والشعر والتراجم والطبقات، والتاريخ الإسلامي العام، وكتب المذاهب والفرق الإسلامية المختلفة؛ ويخوض غمار البحث في كتب التفسير والحديث واللغة والنحو والفقه وأصوله… إلخ، جهد جبار إذا أكدنا أن أحمد أمين قد قام بذلك بمفرده، ودونما معاونة ولا مساندة ولا دعم من أي جهة كانت؛ بل بإرادته وعزمه فقط!
أما آخر هذه التحديات فقد كان في السيطرة على هذه المادة الهائلة، وإعادة تنظيمها وتبويبها حتى يستوي له الشكل والإطار والمنهج الذي يريد؛ ويخرج كتابه حسن التبويب والتقسيم؛ أبوابه تفضي إلى فصوله، وفصوله تفضي إلى مباحثه وفقراته.. إلخ.
وفي سبيل ذلك رسم لنفسه خطة واضحة محددة المعالم، وصار على هديها في إنجاز بحثه؛ فحدد أولًا الإطار الزمني والجغرافي لمعالجة بحثه؛ ثم حدد البيئات «الدينية» و»العرقية» و»الاجتماعية» التي يمكن أن نقول إنها أثرت بدرجة ما في نشوء الأفكار وتطورها منذ ظهور الإسلام بل قبله بقليل، ثم في العصور الإسلامية المتعاقبة.
وهكذا تبلور الجزء الأول من مشروعه الضخم «فجر الإسلام» الذي عالج فيه المائتي سنة التي سبقت ظهور الإسلام، والبيئات الثقافية المتاخمة للجزيرة العربية مهد الإسلام، والثقافات الدينية التي كانت سابقة على ظهور الإسلام، فتناول الفرس وثقافتهم، واليونان والهند، كما تناول ديانات النصرانية، واليهودية، والوثنية.. كل ذلك فيما يتماس أو يتقاطع أو يتوازى مع الإسلام وظهوره، ومع ما أحدثه من ثورة كبرى على كل المستويات.
ثم يعالج نشأة المذاهب والفرق في الإسلام في القرن الأول الهجري، فيتحدث عن نشأة الخوارج، ثم الشيعة ثم المعتزلة، حيث لم تكن الأمة العربية إبان القرن الأول للهجرة «تحيا حياة عقلية يسيرة سهلة كما يظن الناس، وإنما كانت حياتها العقلية خلاصة معقدة لطائفة كثيرة من العناصر اشتبكت وتداخل بعضها في بعض حتى نشأ عنها هذا المزاج الذي ساد في بني أمية».
فهو؛ أي هذا المزاج العقلي «مزيج من أثر الحياة الجاهلية، وأثر للإسلام وللمسيحية التي فيها السامي واليونان، وأثر للمجوسية الفارسية، كما يمكن أيضاً أثر الديانات الهندية على اختلافها وللحضارات المختلفة لكل هذه الأمم التي ذكرت أسماءها».
(وللحديث بقية)
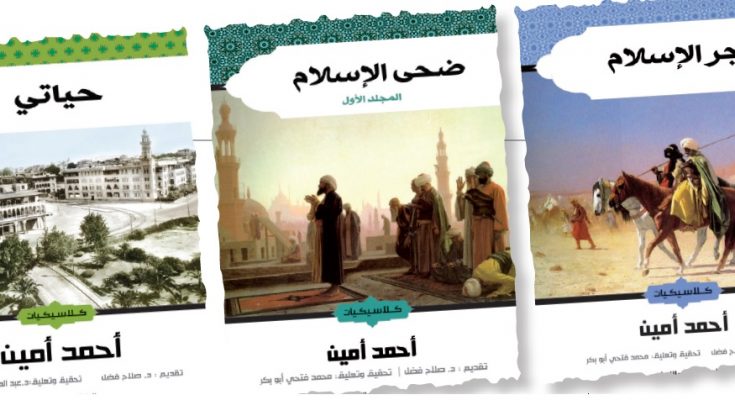
By amrأبريل 13, 2020, 16:38 مالتعليقات على موسوعة أحمد أمين..تاريخ الحياة الفكرية للمسلمين في خمسة قرون مغلقة