صالون الرأي
في الطريق إلى أكتوبر (3)
 By amrأكتوبر 01, 2023, 16:04 م
By amrأكتوبر 01, 2023, 16:04 م
628
بعد إجازة صيفية من الدراسة، هي الأغرب فى كل الإجازات التي عرفناها فلا فسحة ولا راحة ولا استجمام ولا طعم للحياة كلها، فى ظل ظروف اقتصادية ومعيشية ومعنوية هي الأسوأ على الإطلاق، فليس أصعب ولا أمر على المرء من تحول سقف آماله من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، كنا نعيش واقعًا لا يستطيع الواحد منا أن ينظر فى عين أبيه أو أمه أو أخيه أو صديقه لسبب واحد، هو أنه لن يجد فيها إلا المزيد من الحسرة وخيبة الأمل.
بدأ العام الدراسي 1967 – 1968 وذهبنا إلى المدرسة أنا وزملائي من طلاب الصف الثالث الثانوي، وكأننا نساق إليها مُجبرين مُسخرين لا طلاب علم مقبلين على مرحلة هي الأهم فى تقرير مصيرنا وتحديد مسار المستقبل الذي نبتغيه، وقد كانت اختياراتي من قبل بلا حدود وكم حلقت بسقف آمالى من سماء إلى سماء، كنت وأنا طفل صغير أسمع صوت المطرب سيد إسماعيل، وهو يغني يا صحرا مهندس جاي يرويكي بعيون الماي يا صحرا مهندس قال هيخلي ترابك أموال الحصوة تنباع بريال والحجرة بريال وشوي.
فأحلم بأن ألتحق بكلية الزراعة وأصبح مهندسًا زراعيًا يستصلح الصحراء ويزرعها، وأسمع قصص أبطال البحرية جلال الدسوقي والبطل السوري جول جمال وما فعلاه مع زملائهما فى معركة البرلس ضد الأسطول الإنجليزي عام 1956، فأقررالالتحاق بالكلية البحرية لألحق بركب هؤلاء الأبطال. وأسمع فى الصباح صوت الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر يفسر القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأرى وألاحظ مدى اهتمام والداي بسماعه وانتظاره كل يوم فى نفس الموعد فأحلم أن ألتحق بالأزهر الشريف لأكون عالمًا جليلًا مثل ذلك الشيخ …إلخ.
أما الآن فقد انحصرت كل اختياراتي فى شيء واحد هو الالتحاق بالقوات المسلحة ضابطًا من خلال الإلتحاق بالكلية الحربية أو التطوع كجندي أو ضابط صف إذا لم أوفق بالإلتحاق بالكلية الحربية .. نعم لقد تحدد الطريق وهو طريق بلا عودة -إنها الأرض والتراب الوطني، إنه العرض الذي تهون من أجله الأرواح وقد حدد عبدالناصر باسم الشعب كله.
«إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة»
ويلاحظ والدي -رحمه الله- إنصرافى عن المذاكرة، وعن الاهتمام بدروسي كما كنت من قبل، فيسألني لماذا توقفت عن كتابة الشعر، وهو الذي كان كثيرًا ما يبدي قلقه من كثرة اهتمامي بكتابة الشعر ويخشى أن يكون خصمًا من اهتمامي بمذاكرة دروسي، ورويدًا رويدًا يحاول تشجيعي بأسلوب غير مباشر فيقرب مني بعض دواوين الشعر التي أحبها مثل الشوقيات لأحمد شوقي الذي كنت مولعًا به، ويروي لي قصص الحروب والهزائم التي تعرضت لها دول كبرى ثم حولت هزيمتها إلى نصر كبير، ويوجهني إلى الاهتمام بصحتي وبلياقتي البدنية طالما كنت راغبًا فى الالتحاق بالكلية الحربية، وبعد جهد ومثابرة من والدي استجبت له وبدأت أغير نظام حياتي وأواظب على رفع لياقتي البدنية، فلا يمر يوم دون أن أقوم باختراق ضاحية لا تقل عن 3 : 5 كم وهي المسافة بين قريتنا وقريتين مجاورتين أحدهما 3كم والأخرى 5كم، وكان ذلك ليلًا أو فى الصباح الباكر – فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة قبل نهاية العام الدراسى – وعدت إلى مذاكرة كل الدروس التى فاتتنى بإصرار وحماس، وينتهى العام الدراسى بامتحان الثانوية العامة، وأنجح وأحصل على مجموع يؤهلنى للالتحاق بمعظم الكليات ولكني أصر على هدفى فلا أقدم أوراقي إلا للكلية الحربية، وأنال شرف الالتحاق بها بفضل الله وكرمه.
وفى الكلية الحربية – مصنع الرجال- حياة أخرى بكل مقاييس الحياة فقد مر علينا «الترم» المرحلة الدراسية الأولى وفيها فترة المستجدين لم نكن نشعر متى بدأ اليوم ولا متى انتهى، إن الطالب فيها يستيقظ فى الساعة الخامسة والنصف صباحًا ويبدأ يومه بالدوران كأنه ترس فى آلة لا تتوقف حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً عندما تطلق الميكرفونات فى العنابر «نوبة نوم» فينام الطالب فوق سريره الذي لم يره منذ نوبة صحيان إلى أن يهب مرة أخرى فى صباح اليوم التالي.
كان التدريب مركزًا وشديدًا، فلا وقت لدينا نضيعه فى الراحة أو سواها.
لم يكن التدريب فى الكلية الحربية بعيدًا عن نشاط العدو وضغطه، وكان طبيعيًا أن نسمع صوت صفارات الإنذار أثناء الدراسة فننطلق إلى النزول فى حفر الدفاع الجوي السلبي التي تقينا من شظايا قنابل العدو وصواريخه وتمر طائرات العدو من فوقنا لتهاجم مطار ألماظه المجاور للكلية أو تحاول مهاجمة الكلية ذاتها فتواجهها وسائل الدفاع الجوي للكلية بنيرانها الكثيفة فتقصيها بعيدًا.
وبعد خمسة عشر شهرًا قضيتها ودفعتي فى الكلية الحربية هي مدة الدراسة التي درسنا فيها ما يتم دراسته فى ثلاث سنوات بتركيز شديد يتم تخرجنا فى يوم لم نشعر فيه بتلك الفرحة التي ينتظرها ويشعر بها كل خريج، والسبب هو ضرب الطيران الإسرائيلي لمصنع أبوزعبل فى ذلك اليوم 12 فبراير1970، وقد كنا نحن الخريجين من تخصص الاستطلاع نمر بجوار المصنع وقت مهاجمته بالطيران -حيث كانت حركتنا من مدرسة المظلات فى أنشاص التي كنا نتلقى فيها فرقة القفز بالمظلات، إلى الكلية الحربية لنعرف عند وصولنا إليه أن ذلك يوم تخرجنا، ويتم تخرجنا بعد آخر ضوء، لكي نتوجه فى اليوم التالي إلى وحداتنا فى جبهة القتال.
وأنتقل إلى وحدتي الجديدة التي كنت أحلم بالانضمام إليها، والتي لم يكن الانضمام إليها بالأمر السهل بل إن الانضمام إلى تخصص الاستطلاع فى الكلية لم يكن سهلًا -حيث كان يحتاج إلى مواصفات غاية فى القوة والتفوق فى العديد من الأمور.
وفى تلك الوحدة الجديدة كانت الثقة فى النصر تزداد يومًا بعد يوم إلى أن جاء يوم وجاءت ليلة كانت ليلة دندرة فى دندرة، ودندرة الأولى معناها انقلب عاليها واطيها أما دندرة الثانية فهي قرية فى محافظة قنا تبعد عن القاهرة مسافة 665كم وتقع شمال مدينة الأقصر بحوالي 55كم على شاطئ النيل الغربي مقابلة لمدينة قنا تقريبًا على الضفة الشرقية.
ويوجد بها -أي بقرية دندرة- معبد من أهم معابد قدماء المصريين وهو معبد «وهاتور» وهاتور أو حاتور هي إلهة الحب والجمال والأمومة عند قدماء المصريين، ويعرف المعبد أيضًا باسم معبد «دندرة».
فى هذه القرية حطت رحالنا يوم 28 سبتمبر عام 1970، نحن ضباط الاستطلاع ضمن كتيبة استطلاع الفرقة المشاة التي انتقلت إلى منطقة دندرة بالقرب من المعبد المذكور، استعدادًا لتنفيذ مشروع تكتيكي بجنود، عبارة عن اقتحام مانع مائي -مثل قناة السويس- وهو نهر النيل والاستيلاء على الضفة الشرقية وتدمير العدو الموجود عليها والتقدم شرقًا لاستكمال تدمير باقي قوات العدو والاستيلاء على الأرض وتطوير الهجوم شرقًا حتى شاطئ البحر الأحمر.
سبق هذه الليلة عدة أيام فى منطقة تمركز الفرقة عندما استقبلنا ضباط كتيبة الاستطلاع -أنا وزميلاي النقيب عبدالهادي والضابط الأمين -نحن ضباط استطلاع الرئاسة العامة أو الاستطلاع الاستراتيجي، الذين انضممنا عليهم للعمل كمحكمين أثناء تنفيذهم للمشروع التكتيكي بجنود ضمن فرقتهم، كان الاستقبال حارًا وكريمًا، خاصة من قائد الكتيبة وقادة السرايا، أما نظراؤنا من قادة المجموعات الذين جئنا للتحكيم عليهم، فهم يروننا مثلهم لا فرق بيننا وبينهم مثل هذه السمعة التي تسبقنا بأننا نمثل صفوة الضباط وأننا نجوب سيناء ذهابًا وإيابًا للعمل خلف خطوط العدو، وأن الزعيم جمال عبد الناصر يلتقينا فى كل مرة نعود فيها من سيناء وكثيرًا ما كانوا يتحينون أي فرصة لإظهار مهاراتهم أمامنا ومحاولة جس نبضنا فى بعض المهارات والمعلومات كتلك الحركة التي قام فيها أحدهم بتوجيه بعض الأسئلة إلينا ونحن فى معسكر كتيبتهم، عن مسافات الجبال التى حولنا، وكنا نحن الثلاثة نقوم بالإجابة بتقدير المسافة بمجرد النظر دون استخدام أي وسائل فنية مساعدة ولم يزد الفرق بين تقديراتنا عن نصف كيلومتر، ولم نكن نقدر مسافة أي جبل منهم من مكاننا بأكثر من عشرة كيلومترات فانفجر هذا الضابط ضاحكًا وهو يسخر من إجاباتنا أمام زملائه، بأنه سبق له قياس مسافات هذه الجبال وأخذ يحدد كل جبل ولم يكن تقديره لأي جبل يقل عن ثلاثين كيلومترًا.
لم نذق طعم النوم ليلتها، خاصة بعد أن رأينا نظراتهم إلينا وما أن خلونا فى مكان المبيت المخصص لنا، وكان عبارة عن ملجأ تحت الأرض – حتى أخذنا نراجع أنفسنا ومعلوماتنا وخلصنا إلى أن تقديراتنا لا يمكن أن تكون بهذا الخطأ وقررت أنا والنقيب عبدالهادي أن نقوم بالتحرك إلى أبعد جبل وقياس مسافته سيرًا على الأقدام مع شروق شمس اليوم التالي كي نقطع الشك باليقين، وعهدنا إلى الضابط الأمين أن يبقى فى الكتيبة لكي يغطي أمرنا ولا يكشفه أحد حتى نعود وكانت أمامنا مشكلة أنه لا يوجد معنا أي معدات ملاحة «بوصلة» ولا خرائط ولا سلاح يحمينا، ولو أننا طلبناه من قيادة الكتيبة سوف ينكشف أمرنا – إضافة إلى نقطة هامة هي أن كل منشآت الكتيبة مخفية تحت الأرض لا يظهر منها شيء.
الأمر الذي يزيد من صعوبه العودة مرة أخرى إلى نفس المكان، ورغم هذا قررنا استحضار كل ما لدينا من مهارة ومن خبرة سابقة للنقيب عبدالهادي الذي سبق له العمل فى سيناء خلف خطوط العدو، أما أنا فلم يكن مضى على تخرجي عام واحد.
ونجحنا فى الوصول إلى الجبل والصعود إلى قمته وكتابة أسمائنا وتوقيت تواجدنا على برميل موجود فوقه يمثل علامة جغرافية، وعدنا بعد خمس ساعات إلى معسكر الكتيبة ودخلنا إلى ميس الضباط فوجدناهم جميعًا يتناولون الغداء، ورحنا نداعبهم ونكرر عليهم ما فعلوه معنا بالأمس وهم فى حيرة من أمرنا، حتى كشفنا لهم ما فعلناه وأن تقديراتنا هي الصحيحة، وهنا ضحك أحد قادة السرايا الذي حضر موقف اليوم السابق وأخبرنا أنهم يعلمون المسافات الحقيقية ولكنهم كانوا يحاولون اختبار قدراتنا، وقرر أن يعد لنا عشاءً فاخرًا على نفقته تقديرًا لما فعلناه، وأخذ أحدهم يردد: «له حق عبد الناصر يلقاكم كل يوم»، ويرد آخر: «احكولنا ماذا يقول لكم».
أخبرناهم أن النقيب عبد الهادي هو الذي التقاه لأنه هو الذي سبق له دخول سيناء والعمل خلف خطوط العدو، أما الأمين وأنا ففى انتظار دورنا، وراح عبدالهادي بعد إلحاح شديد منهم يروي فى اقتضاب كيف دخل هو وزملاؤه ومعهم المدير إلى بيت عبدالناصر وجلسوا فى غرفة الاستقبال التي كان الأثاث الموجود بها قديمًا ولا يبدو عليه أي مظهر من مظاهر الثراء، بل أقل كثيرًا من أثاثات أخرى رآها من قبل وأن عبدالناصر حين دخل عليهم وصافحهم، أحس كل واحد منهم أنه التقاه من قبل وبمرور الوقت كانوا يشعرون بدفء حديثه، وبمناقشته لهم ولأحوالهم وكيفية تصرف العدو فى سيناء، قرب إليهم الإحساس أنه كان معهم فى سيناء من كثرة استفساراته عن الأماكن ودقتها، ووصفه للعدو كأنه كان بينهم وهم يراقبونه.
ويسأل أحد الضباط النقيب عبدالهادي، ماذا كان يرتدي عبدالناصر حين التقاكم؟ ويرد عبد الهادي: «كانت بدلته منحولة وبرتها كأنه يلبسها منذ تولي الرئاسة».
عودة إلى قرية دندرة على البر الغربي للنيل، حيث كان تجمع القوات انتظارًا لبدء تنفيذ المشروع التدريبي -وكان الجميع مشغولين بعملية الإعداد والتجهيز للمشروع ولا وقت عندنا نحن الضباط للتجمع قبل الانتهاء، مما بين أيدينا من أعمال أذكر أني بعد فراغي من عملي وتوجهي لمكان المبيت وجدت عددًا من الزملاء، يجهشون فى البكاء بصورة لم أشهدها من قبل، وبعد جهد جهيد فى محاولة الاستفسار عن أي منهم عما حدث وما هو سبب البكاء، رد أحدهم بصوت غير مفهوم من شدة البكاء والنحيب: «عبدالناصر مات»، فتركته وتوجهت بالسؤال إلى آخر فرد بنفس العبارة: «عبدالناصر مات» .. فى البداية كنت أحسبهم دبروا هذا المشهد كنوع من المقالب التي يقومون بها معنا على سبيل المزاح، ولكني ما إن تأكدت من الخبر إلا وانتابتني نفس الحالة التي هم عليها بعد أن حاولت إظهار رباطة جأشي وتماسكي لمدة دقائق معدودة لم أستطع تجاوزها، وأصبحت حالتنا كلها دندرة فى دندرة، وانقلب كل شيء حولنا ..
فلا تقع عينك على إنسان إلا وتجده يبكي أو تسمع نحيبه.
وصدرت الأوامر بإيقاف المشروع التدريبي مؤقتًا .. وبقيت القوات فى أماكنها .. حتى جاء اليوم المشهود يوم الأول من أكتوبر 1970 – يوم وداع الزعيم وإيداعه القبر – وحاولنا جهدنا البحث عن أي مكان به جهاز تلفزيون. لمشاهدة الجنازة، حتى نجحنا فى الوصول إلى ملجأ أحد القادة وهو عبارة عن مكان مجهز تحت الأرض على عمق عشرة أمتار ومبطن بشبكة من الحديد أشبه «بقفص القرود»، وهذا أيضًا نفس الاسم الذي يطلق عليه، وهو لا يسع فى داخله أكثر من عشرة أفراد جلوس على الأرض أو على الكراسي، ولكنه فى ذلك التوقيت كان به أكثر من خمسين فردًا، جاءوا لمشاهدة الجنازة على جهاز التلفزيون الموجود، وهو مقاس اثنتي عشر بوصة أبيض وأسود، ويتم إمداده بالكهرباء من إحدى البطاريات السائلة.
كان المشهد مهيبًا وتعرض بعضنا للاختناق أكثر من مرة، نظرًا لضيق المكان، وانتاب معظمنا حالة هستيرية من البكاء، وانتهى أطول يوم مر علينا، وخرجنا من تحت الأرض نجر أرجلنا فى إعياء لم نشهده من قبل، ماذا بعد؟ .. كان هذا هو السؤال الذي يدور فى أذهان الجميع، من البديل وما العمل؟ هل ضاعت أحلامنا؟ ويقطع هذه الحالة من اليأس والألم، إعلان عن مؤتمر لقائد الفرقة يحضره جميع الضباط -وتوجهنا جميعًا فى التوقيت المحدد- وكان ليلًا – إلى مكان المؤتمر وجلسنا فى صمت مطبق لا يسمع فيه إلا صوت زفرات تخرج من صدورنا كأنها تخرج من فوهة بركان، قطعه دخول قائد الفرقة ووقوفنا لتحيته، ثم بدأ حديثه بسؤال استنكاري: «هل حقًا تحبون عبدالناصر؟».
وتلفتنا ننظر إلى بعضنا البعض قبل أن نثبت عيوننا عليه مستنكرين السؤال ونحن نردد فى همهمات.. نعم.
*أروني هذا فى المشروع -اجعلوا العالم يعرف ماذا ترك عبدالناصر خلفه من رجال .. إذا كنتم حقًا تحبونه فأظهروا كل
ما تعلمتموه منه وكل ما فعله من أجلكم ومن أجل وطننا حتى لاقى ربه.
وبدأ المشروع فى التوقيت الجديد الذي أعلنه قائد الفرقة، وأخذت القوات تتحرك على الأرض وتقتحم نهر النيل -الذي يمثل قناة السويس- وتنطلق فى اتجاه الشرق بعد القضاء على الدفاعات التي واجهتنا بكفاءة فاقت كل التقديرات وتواصل التقدم على محور قفط القصير -أي من بلدة قفط الواقعة على النيل فى اتجاه مدينة القصير على البحر الأحمر – وتقوم بأروع عملية تطويق مزدوجة من كلا الجانبين لقوات العدو -الممثلة على الأرض بجزء من قواتنا -بصورة شهد لها كل الخبراء والمحكمين.
كانت هناك العديد من المواقف الصعبة التي يفرضها المحكمون وطاقم الإدارة على القوات وقيادتها، كأنهم فى حرب حقيقية، وكان تصرف القادة والقوات يظهر مدى ما توصلوا إليه من مستوى تدريبي عال، واحترافية تقدر مسئوليتها التي أوكلها لها الوطن.
وانتهى المشروع -التدريبي- التكتيكي بجنود، وعدنا نشعر
فى داخلنا بقدر من الثقة فى قواتنا وقادتنا وأنفسنا وأن حقنا لن يضيع.
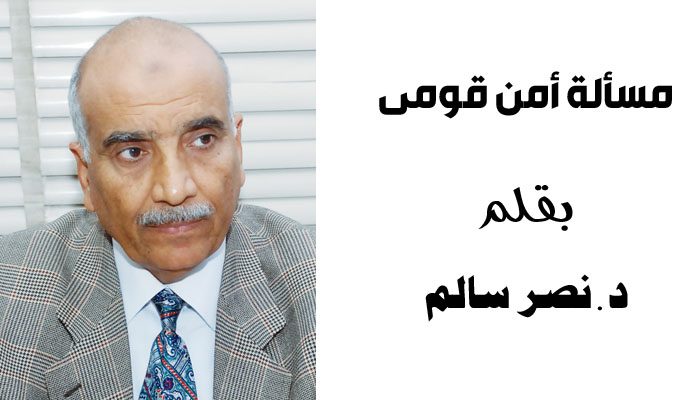
By amrأكتوبر 01, 2023, 16:04 مالتعليقات على في الطريق إلى أكتوبر (3) مغلقة












