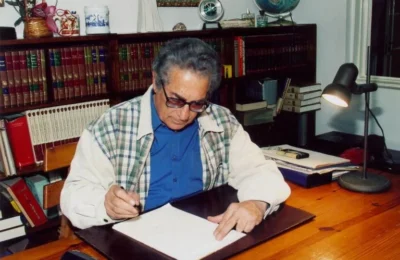صالون الرأي
العقاد وثورة يوليو
 By amrأغسطس 22, 2021, 20:01 م
By amrأغسطس 22, 2021, 20:01 م
1839
يقول العقاد عن نفسه: لقد حاربت الطغيان، وحاربت الفوضى، لقد حاربت التقليد الأعمى والدجل المريب باسم الدين، لقد حاربت رءوس الأموال، وحاربت مذاهب الهدم والبغضاء، لقد حاربت الجمود والرجعية، وحاربت الأحزاب، وحاربت الملوك، لقد حاربت هتلر، ونابليون، وحاربت المستعمرين، لقد حاربت الصهيونية وحاربت النازية أكبر أعداء الصهيونية، وحاربنى كل هؤلاء إلى جانب صاحب اللحية والعذبة باسم الدين، لقد نكب هذا البلد المسكين بداء الاستبداد القديم فصارت قيم الناس مرهونة بتقدير الحاكم، فلا مقام لأحد بغير لقب ولا حسب ولا جاه وبلغ من عبادة الأوثان أن “الصوفية” فى هذا البلد منذ قرون وعاشت على المظاهر والألقاب، وبين منتسب إلى هذا الضريح ومنتسب إلى هذا الهيكل ومعهم أشتات من الرايات والفوانيس.
هكذا كان العقاد ثوريا قبل الثورة، وقد حكم عليه بالسجن – فى سنة 1928 وكان عضوا فى البرلمان فوقف يهاجم “أعداء الأمة وأعداء الدستور” وقال كلمته المشهورة “إن الأمة على استعداد لسحق أكبر رأس فى البلد يخون الأمة ويعتدى على الدستور”، وفهم القصد أن المقصود بهذه الكلمة هو الملك فؤاد، فلما حلت الحكومة البرلمان وزالت عنه الحصانة دبرت حكومة إسماعيل صدقى له قضية العيب فى الذات الملكية فحكمت المحكمة بحبسه تسعة أشهر، وكان قد قيل له: إن مقالاتك تراجع فى بعض الدوائر مراجعة خاصة، وإنهم ينتظرون يوما ربما كتبت فيه ما يساعد على تأييد التهمة ثم يقدمونك إلى المحاكمة بما جمعوا من أدلة قديمة وحديثة.
كان العقاد، حريصا على حريته ككاتب وصاحب رأى، ومعاد للملك وللسياسيين الفاسدين والأحزاب الفاسدة، ومعاد للنظم الشمولية عموما، ولذلك عندما اشتعلت الحرب العالمية الثانية بين الدول “الديمقراطية” الغربية وبين النازية الألمانية والفاشية الإيطالية كان مؤيدا للدول الغربية، وهاجم النازية مبكرا فى كتاب بعنوان “هتلر” صدر سنة 1940 أى بعد قيام الحرب بسنة واحدة، وكان هتلر وقتها يسجل أعظم انتصاراته، ولم يكتف بذلك بل كان يلقى بأحاديث فى الإذاعات ضد هتلر والنازية وضد إذاعة ألمانيا النازية من برلين، وكانت إذاعة برلين تهاجمه بضراوة.. وعندما اقتربت قوات ألمانيا من أبواب مصر اضطر العقاد إلى الهرب إلى السودان خاصة بعد أن أصدرت الحكومة النازية الحكم عليه بالإعدام، وظلت الدعاية البريطانية تعتمد على كتابه ومقالاته المعادية للنازية والفاشية وطلبت القيادة البريطانية فى مصر آلاف النسخ من كتاب “هتلر” وزعتها فى أنحاء البلاد.
فالعقاد ثائر قبل الثورة، وعندما قامت ثورة يوليو كان قد وصل إلى الستين من عمره، وبلغ من الشهرة والمجد الأدبى، والمكانة الاجتماعية ما جعله شديد الاعتزاز بنفسه، بالإضافة إلى شخصيته المترفعة الميالة للعزلة، وربما يكون ذلك هو السبب الذى جعله لا يسارع لإعلان تأييده للثورة، ولم يطلب مقابلة أحد من قادتها، ويذكر الشيخ أحمد حسن الباقورى – وزير الأوقاف فى حكومة الثورة – فى كتابه “بقايا ذكريات” الذى صدر عن مركز الأهرام للنشر عام 1988 أنه عرض على العقاد أن يلتقى مع عبد الناصر فى بيت الشيخ الباقورى، فكان رد العقاد أنه يشترط أن يكون هو آخر الحاضرين بعد أن يتكامل حضور المدعوين، فإذا تراخى عبد الناصر فى القيام لمصافحته فسوف يلعن اليوم الذى جمعه به وينصرف غير آسف على شىء!
وعندما أهدى عبد الناصر إلى العقاد نسخة من كتابه “فلسفة الثورة” كتب العقاد مقالا بعنوان “فلسفة الثورة فى الميزان” وجه فيه النقد إلى الكتاب وسجل رفضه لإلغاء الأحزاب وتحديد الملكية الزراعية وتأميم المصانع والشركات وهذه أهم إنجازات الثورة فى ذلك الوقت، ورفض العقاد اللجوء إلى “إجراءات ثورية” مثل قوانين العزل السياسى، واعتقال المثقفين، وعزل أساتذة الجامعات، وفى عنفوان الثورة سئل العقاد فى حديث صحفى عن “الزعيم” فى رأيه، فقال: الزعيم عندى هو سعد زغلول كان ولا يزال كذلك وليس بعده زعيم، وهو يعلم أن كتاب “فلسفة الثورة” وصف سعد زغلول فى ثورة 1919 بأنه ركب الموجة الثورية، وحين منح عبد الناصر للعقاد جائزة الدولة التقديرية فى احتفال كبير ألقى فيه كلمة بليغة لم يشكر فيها عبد الناصر بل استهل كلمته بقوله: “إنى لأشكر هذا الشعب العظيم على هذا التكريم”، وبذلك لم تكن العلاقة جيدة بين العقاد وعبد الناصر وثورة يوليو كما كانت العلاقة مع طه حسين الذى كان عبد الناصر يعتبره صاحب الدعوة إلى الثورة على الأوضاع القائمة وإقامة العدالة الاجتماعية وإنصاف الفقراء ونشر التعليم بينهم للارتقاء بهم، أو كما كانت علاقة عبد الناصر مع توفيق الحكيم الذى كان عبد الناصر يعتبره ملهما له بروايته الشهيرة “عودة الروح” التى ذكر فيها أن مصر فى انتظار بطل يعيد إليها الكرامة والشرف ويصلح الأحوال.
موقف العقاد كان متسقا مع فكره ومبادئه بالإيمان بالديمقراطية وحرية الرأى، وكان يرى أن الثورة لم تحقق الديمقراطية التى وعدت بها، وإصرارا منه على تجاهل ما يجرى لم يكتب فى السياسة فى هذه الفترة واستمر فى كتاباته التاريخية والأدبية، ولم ينتظر منصبا أو مكسبا، فقد كان هو الكاتب الوحيد فى مصر الذى اختار أن يعيش على قلمه وأن يكون حرا رافضا لكل منصب أو وظيفة، ولم يلجأ إلى عمل ثابت يضمن له دخلا منتظما، ورفض الحصول على الدكتوراه الفخرية، ولم يكن من أهدافه فى الحياة الحصول على ثروة، حرصا منه على أن يظل مستقلا وحرا وغير تابع فى أى صورة من صور التبعية، لذلك لم يطلب منصبا، ولم تمنحه الثورة منصبا، وفى رأى أستاذ التاريخ الدكتور صابر عرب أن العقاد استفاد من البُعد عن السياسة كما استفادت الثقافة العربية من ذلك وأن العقاد يصلح ليكون موضوعا لدراسات علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التاريخ ودارسي الأدب، حيث انصهر فى تراث الأمة العربية، وأضاف إلى كل فروع المعرفة الإنسانية، وكانت آراؤه حادة كالسيف، ومبادؤه راسخة لم تتغير، وهامته عالية، ولا يقبل أنصاف الحلول.
لم يجد العقاد فى عبد الناصر نموذج سعد زغلول الذى ارتبط به ورسخت صفاته فى ذهنه ومواقفه، وعاش عمره معجبا بشخصيته ومؤمنا بأنه الوحيد الذى توافرت فيه شروط الزعامة واستطاع أن يجمع حوله كل طوائف الشعب وسعد زغلول كما وصفته صحيفة التايمز البريطانية بعد وفاته بأنه كانت له مغناطيسية شخصية تجذب إليه الناس، وقال عنه الزعيم الهندى غاندى “إننى أعتبره أستاذى”، ولأن العقاد متصلب فى آرائه ولا يحاول مراجعتها لم يلتفت إلى ما حققته الثورة كما لم يلتفت إلى كاريزما عبد الناصر التى تحدث عنها كل من كتب عنه فى الشرق والغرب، وإن كانت الثورة قد خسرت قلمه وتأييده فإن الأدب والثقافة العربية قد كسبت الكثير من هذا الباب ودخل التاريخ.
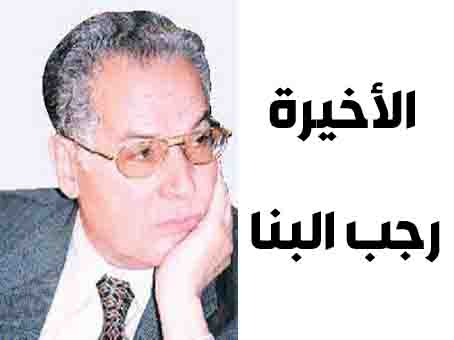
By amrأغسطس 22, 2021, 20:01 مالتعليقات على العقاد وثورة يوليو مغلقة