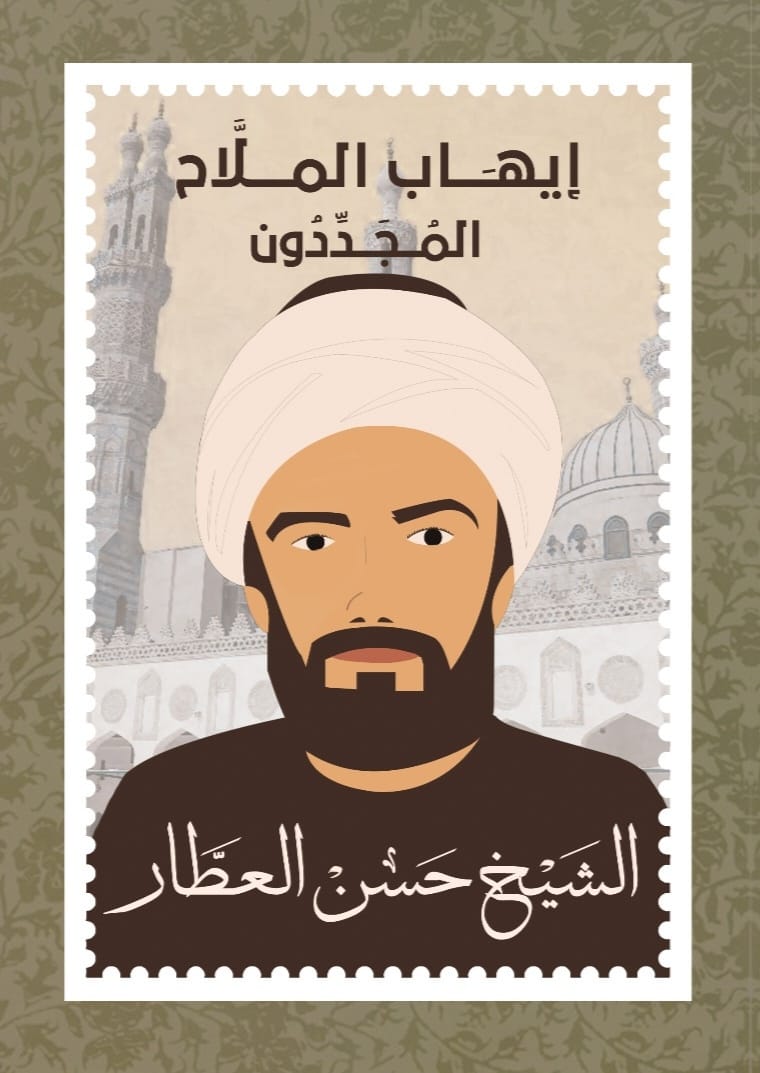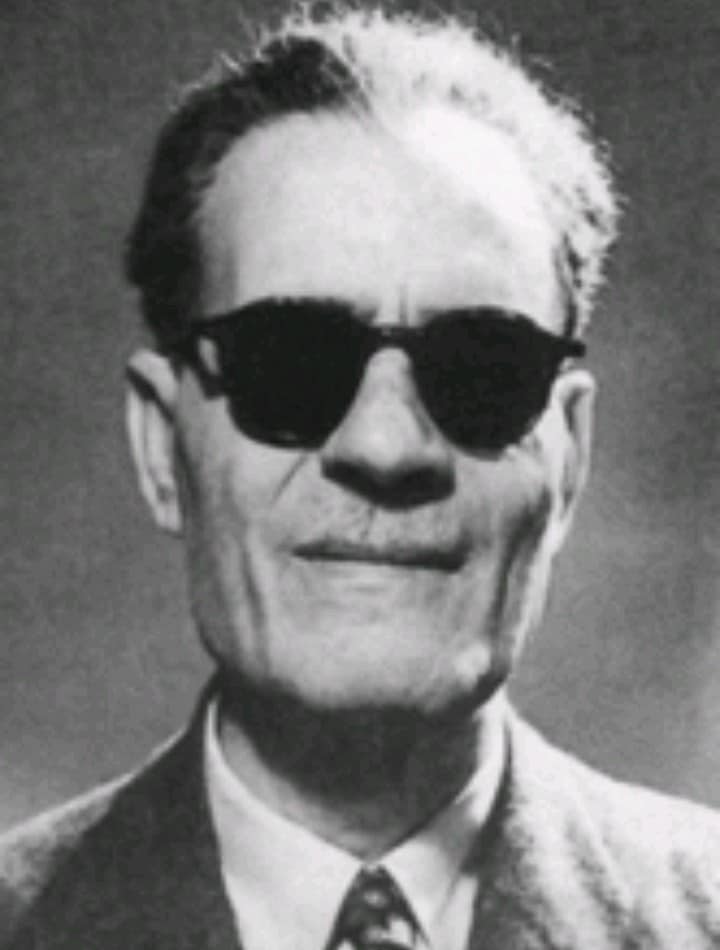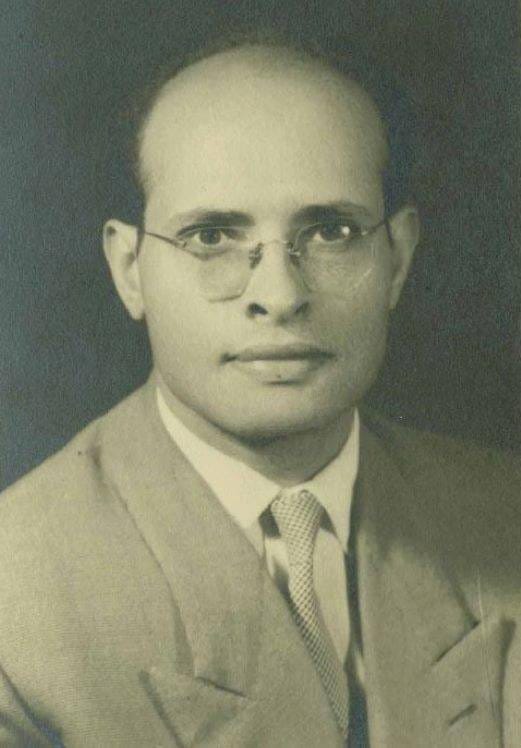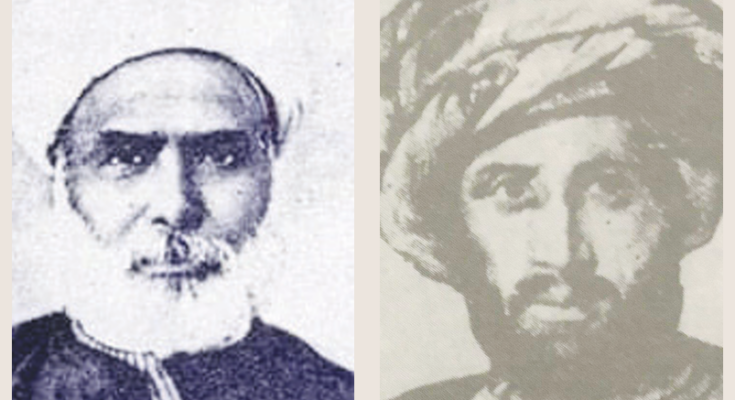
مصر
«العلوم الإنسانية».. ونهضات الأمم المتحضرة!
By amrأغسطس 26, 2024, 15:26 مالتعليقات على «العلوم الإنسانية».. ونهضات الأمم المتحضرة! مغلقة
السابقفي انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة من تفضل الصين.. هاريس أم ترامب؟
التاليتشغيل 3 خدمات اتصالات قبل نهاية العام قفزة جديدة في الحياة العصرية للمصريين